حتى وقت قريب كان بالإمكان أن نطلق على علاقات المملكة العربية السعودية بالجمهورية اللبنانية وصف «النموذجية» لأنها كانت على الدوام متميزة بالتكاتف والتكافوء، وتفهم الأولى لأوضاع وتركيبة الثاني سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا، بل حرصت الرياض دومًا على وجود لبنان كمتنفس ثقافي وتعددي للعرب قاطبة دون أن تلتفت إلى الإساءات الكثيرة التي تعرضت لها من قبل بعض القوى اللبنانية زمن الحرب العربية الباردة.
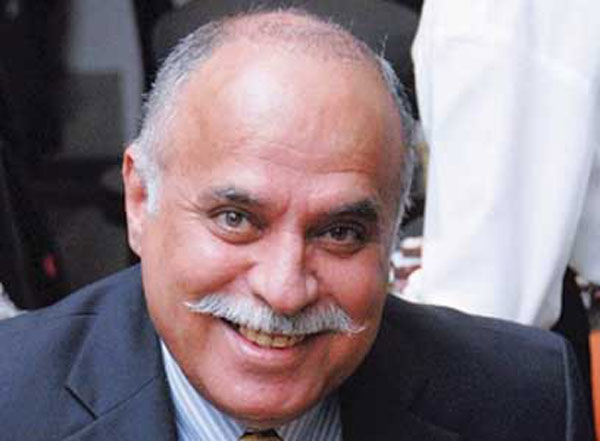
أما الأدلة فأكثر من أن تحصى، لكننا نشير فقط إلى جهود السعودية الخيرة لإخراج لبنان من مستنقع حربه العبثية منذ قمة الرياض السداسية (السعودية والكويت ولبنان ومصر وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية) التي دعا إليها المغفور له الملك خالد بن عبدالعزيز في عام 1976، والتي أثمرت عن إرسال قوات الردع العربية لوضع حد للاحتراب الطائفي، ثم جهودها الحثيثة للتوصل إلى اتفاقية الطائف في عام 1989 والتي أمنت لهذا البلد العودة إلى حياته الطبيعية وأنقذت أرواح شعبه من العنف المجنون، ناهيك عما ضخته السعودية من أموال لإعادة إعماره في أعقاب تلك الاتفاقية، إضافة إلى ملايين أخرى من الدولات لإعادة إعمار ما تسبب حزب الشيطان في تدميره بقراراته «المقاوماتية» المتسرعة.
ولا يفوتنا في هذا السياق التذكير بالمحبة الخاصة التي كان يكنها الراحل الكبير الملك عبدالله بن عبدالعزيز طيب الله ثراه للبنان واللبنانيين، وهي المحبة التي جعلته لا يتردد في قضاء إجازاته في هذا البلد في ستينات وأوائل سبعينات القرن الماضي، رغم الحملات الإعلامية المسعورة التي كانت تشن ضد بلاده من قبل الصحف والتنظيمات اليسارية والقومية المأجورة. وهو أيضا القائل قبل رحيله «إن دعم لبنان واجب علينا جميعا، ومن يقصر في دعم لبنان فهو مقصر في حق نفسه وعروبته وإنسانيته».
إن حرص الرياض على لبنان، بدأ منذ تعاون البلدين في تأسيس الجامعة العربية في عام 1944، وترسخ باجتماع رئيس لبنان المستقل الشيخ بشارة الخوري بسمو ولي العهد الأمير سعود بن عبدالعزيز على هامش قمة أنشاص في عام 1945، وتعزز أكثر باستضافة الملك المؤسس عبدالعزيز طيب الله ثراه للرئيس الأسبق كميل شمعون في الرياض التي وصلها بعيد انتخابه رئيساً في عام 1952، ثم باستضافة الملك سعود طيب الله ثراه للرئيس شمعون مرة أخرى في عام 1955 حينما أرسيا علاقات بلديهما الثنائية على مباديء التعاون والتكاتف والاحترام المتبادل.
كان الهدف من وراء هذه اللفتة السعودية، وما تلاها من فتح أبواب العمل والاستثمار للبنانيين، أفرادًا وشركات، في المملكة وهي في بدايات استثمار مواردها النفطية في مجالات التنمية وتأسيس البنى التحتية الحديثة هو الحفاظ على عروبة لبنان وديمونة كيانه الهش وسط الأعاصير الإقليمية والدولية، وعدم السماح باستغلاله كمخلب قط ضد أشقائه العرب من خلال استغلال نظامه الليبرالي التعددي.
وقد تحقق ذلك للمملكة حينما كان في السلطة زعماء لبنانيون أفذاذ من أمثال الرؤساء كميل شمعون وفؤاد شهاب وشارل الحلو، ووزراء خارجية يقودون الدبلوماسية اللبنانية بحكنة وخبرة الكبار من أمثال شارل مالك وفيليب تقلا والحاج حسين عويني وسليم الحص وفؤاد بطرس وغسان تويني وغيرهم. لكن المعادلة تحولت إلى النقيض حينما سطا عملاء الولي الفقيه الايراني ومن يوالونهم على مقدرات الحكم في بيروت، ونصبوا على رأس الدبلوماسية اللبنانية فتى غر كل مؤهلاته في علم الدبلوماسية والعلاقات الدولية أنه صهر الجنرال المتحالف مع حزب الشيطان.
وهكذا كان انسلاخ لبنان عن الجسد العربي، وطعن ظهيره العربي المتمثل في السعودية وشقيقاتها الخليجيات، والاصطفاف إلى جانب أعداء العرب في المحافل العربية والإقليمية متوقعًا. كيف لا وصاحب الثلث المعطل لقرارات حكومته لا يجد حرجاً في القول إنه جندي من جنود الولي الفقيه في طهران، وإن أجندته «لا تقضي بتحويل لبنان إلى دولة إسلامية، وإنما تحويله إلى جزء من الدولة الإسلامية الكبرى التي يقودها صاحب العصر والزمان» أي الولي الإيراني المتسربل زيفًا بشعارات الممانعة والمقاومة.
وإذا كانت فترة الخمسينات والستينات في التاريخ اللبناني المعاصر والتي انتهت بالحرب الأهلية الأولى في عام 1958، قد برهنت على استغلال لبنان كساحة للصراعات العربية العربية إلى درجة أن سفير الجمهورية العربية المتحدة في بيروت اللواء «عبدالحميد غالب» كان يطلق عليه اسم «المقيم السامي» و«صانع الملوك»، وكان له من النفوذ والتأثير ما ليس لدى نظرائه، فإن حقبة السبعينات، التي كنت شاهدًا عليها بحكم إقامتي في بيروت كطالب جامعي، تميزت بالتصفيات الجسدية بين الفرقاء العرب، واستخدام إسرائيل للساحة اللبنانية لتصفية معاريضها من الفلسطينيين الذين قاموا بدورهم بتصفية بعضهم بعضاً مستغلين انفلات الأمن ونشوء الدويلات الفلسطينية المسلحة ضمن الدولة اللبنانية الهشة أصلاً. لكن الحقبة الحالية، وعلى النقيض من سابقاتها، سمحت بظهور دويلات منسلخة عن هويتها العربية ومؤتمرة بأمرة الأجنبي المعادي للعروبة ولكل ما هو عربي، بل ومنفذة لخططه التدميرية والإرهابية في أكثر من بقعة عربية، ولاسيما في دول الخليج العربية.
وإزاء هذا التحول غير المسبوق، فقد فعلت الرياض حسناً بموقفها الجريء مؤخرًا حينما أوقفت مساعدتها للجيش والأمن اللبنانين، ودعت مواطنيها للخروج مما كان يعرف يومًا بـ «لبنان الأخضر الحلو»، والذي صار اليوم غرابا ينعق باسم طهران. ومثل هذا الموقف يأتي في سياق السياسات الخارجية الجريئة للمملكة العربية السعودية ولشقيقاتها الخليجيات والقائمة على مبدأ «لا تهاون بعد اليوم ولا تردد مع من يتطاول علينا صراحةً أو لمزًا».
 خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس



