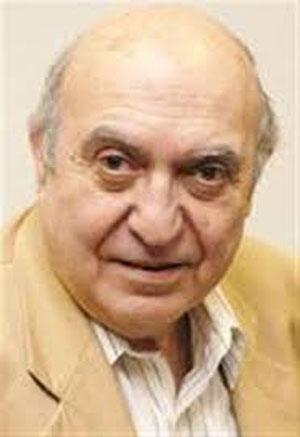
بين دعواته المتكررة لتنحي الرئيس السوري بشار الأسد عن السلطة، وتأكيداته – المتكررة أيضًا – لانهيار شرعيته، وتهديده العلني بقصف أهداف سورية عسكرية بعد تجاوز النظام «الخط الأحمر» عام 2012.. إلى التنسيق العسكري مع روسيا على محاربة ألد أعداء هذا النظام («داعش» وأخواتها)… يكون الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قد حقق استدارة بمعدل 180 درجة في موقفه السياسي والعسكري المعلن من النظام السوري.
بمنطق سياسي عادي، تعتبر هذه الاستدارة إنجازًا «مكيافيليًا» لا يعلى عليه. وإذا كان من الصعب فصله عن شخصية أوباما وقناعاته الذاتية، فمن الأصعب أيضًا تبرئة مؤسسة القرار الأميركية كلها من هذا التحول.
تطورات دولية عدة ساهمت في إعادة خلط الأوراق التقليدية لدبلوماسية واشنطن أبرزها، قطعًا، انهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991 وأحداث سبتمبر (أيلول) 2001.
يوم أنزل، للمرة الأخيرة، علم المطرقة والمنجل عن مبنى الكرملين، في 25 ديسمبر (كانون الأول) 1991، لم يدر بخلد الكثيرين أن الولايات المتحدة ربحت الحرب الباردة.. وخسرت الثوابت الأساسية لسياستها الخارجية.
لغاية اليوم، ما زالت واشنطن عاجزة عن الخروج بمبدأ دولي عريض يشكل بديلاً مقبولاً لسياسة «احتواء» الاتحاد السوفياتي التي سقطت مع الاتحاد السوفياتي.
منذ 25 سنة – تاريخ انهيار المنظومة السوفياتية – وقبل سنوات من وصول الرئيس أوباما إلى البيت الأبيض، والدبلوماسية الأميركية تعاني عقدة غياب الترابط المصلحي والمبدئي بين مكوناتها، الأمر الذي حمل بعض المحللين على اعتبارها أقرب إلى الأحجية منها إلى المنحى الواضح والمستقيم، فلا غرابة أن يتذمر شركاؤها الأوروبيون في حلف شمال الأطلسي من «ليونة» التزاماتها الأطلسية حيالهم ويحملونها مسؤولية إتاحة الفرصة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لتسجيل نقاط عدة على النفوذ الأميركي والغربي في القوقاز وشبه جزيرة القرم وأوكرانيا الشرقية. وأحدث دليل على القلق الأوروبي من مواقف واشنطن إصرار كل من بولندا ورومانيا على أن تنشر الولايات المتحدة دروعًا صاروخية في أراضيهما كضمانة نفسية وعسكرية لثبات التزاماتها الدفاعية تجاههما.
أما أصدقاء الولايات المتحدة في الشرق الأقصى فلا يقلون عن حلفائها الأطلسيين تساؤلاً عن مدى استعدادها للدفاع عن موقع الدولة الأكثر نفوذًا في منطقة المحيط الهادئ وما إذا كانت تفضل، في حالة الضرورة القصوى، التعايش مع النفوذ الصيني على «احتوائه».
ولا تخلو دبلوماسيتها الشرق أوسطية من طابع الأحجية، فواشنطن لم تجد حرجًا في تجاوز خلافاتها العميقة مع إيران ومنحها «مهلة مناورة» ثمينة لمتابعة برنامجها النووي، وفي الوقت نفسه تشديد حصارها المالي والسياسي لذراعها العسكرية المسمى بحزب الله.
وفي السياق نفسه لم ترَ واشنطن مانعًا من إغضاب حليفها الأوثق في الشرق الأوسط، إسرائيل، بموقفها المتسامح من برنامج إيران النووي؛ الأمر الذي ردت عليه إسرائيل بتوثيق التنسيق العسكري في الحرب السورية مع خصمها الدولي روسيا.
وكذلك لم تتورع واشنطن عن خذل حليفتها الأطلسية تركيا، ورفض مطلبها فرض منطقة حظر جوي على طول حدودها مع سوريا.. والذهاب إلى حد تجاهل كل موجبات التحالف العسكري معها بتدريب وتسليح خصومها من ميليشيات كردية في سوريا.
أحداث 11 سبتمبر 2001 لم يقل تأثيرها في الرؤية الأميركية العامة لدبلوماسيتها الخارجية عن تأثير انهيار الاتحاد السوفياتي، فبعد 11 سبتمبر 2001 اكتشفت الولايات المتحدة أنها لم تعد «سوبر دولة»، بل دولة أخرى مثل باقي دول العالم معرض أمنها الداخلي، مثلها للأخطار الخارجية والاختراق.
بروز «الإرهاب الدولي» كخطر خارجي يهدد أمن الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين حمل واشنطن على تقديم متطلبات أمنها الداخلي على الاعتبارات التقليدية لاستراتيجيتها الدولية، الأمر الذي يعكسه ما فرضته من تعديلات جذرية على قوانينها وأجهزة استخباراتها وإنفاقها الحكومي…
منذ سبتمبر 2001 والولايات المتحدة تنظر إلى الأزمات الدولية من منظور يأخذ في الحسبان، إلى جانب تبعاتها على مصالحها الخارجية، تداعياتها المحتملة على أمنها الداخلي، فأصبحت واشنطن كلاعب البلياردو: تضرب كرة ما لتصيب كرة أخرى.. خصوصًا في الشرق الأوسط.
نقلا عن ایلاف
 خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس
خلیج فارس بخش عربی خبرنامه خلیج فارس



